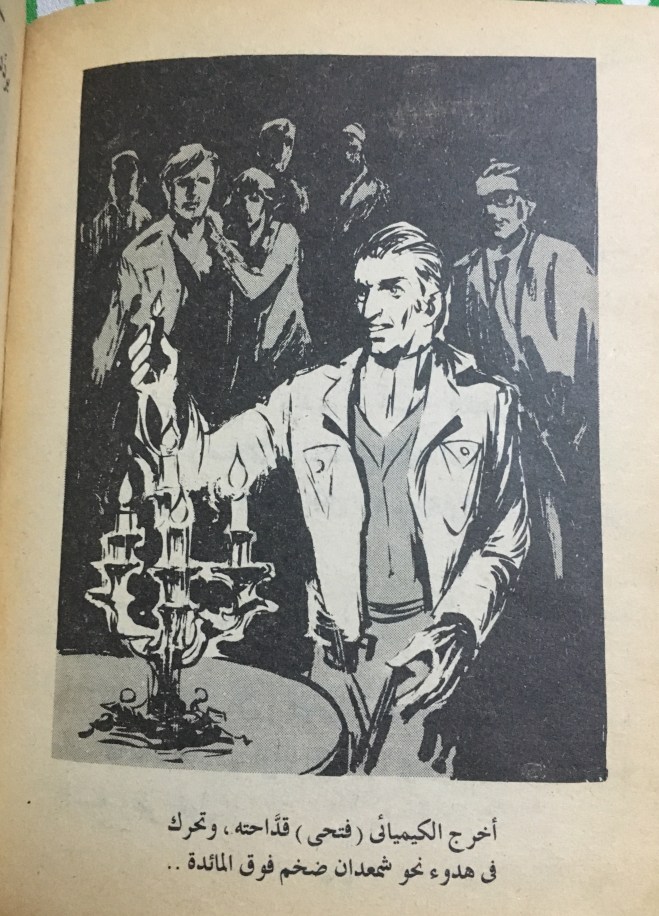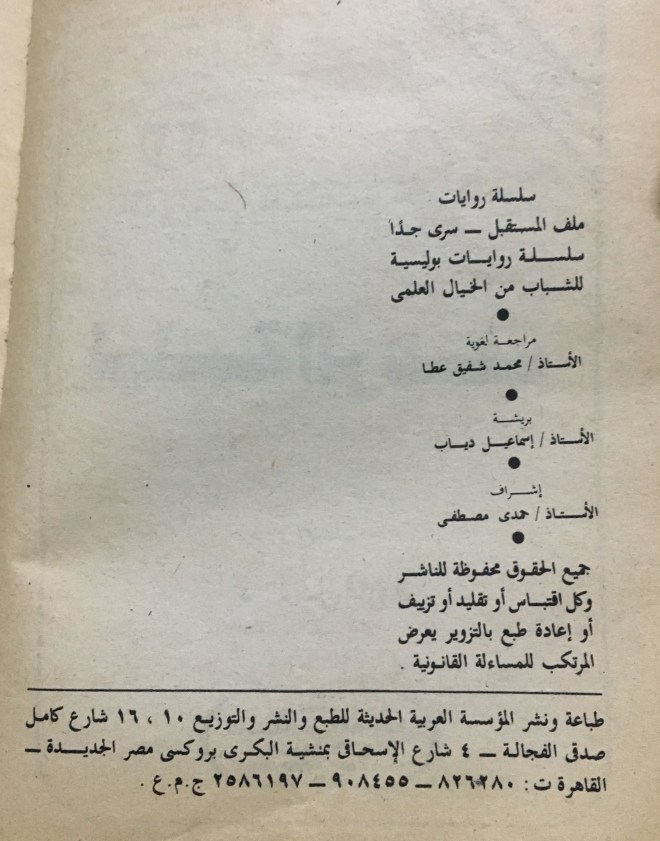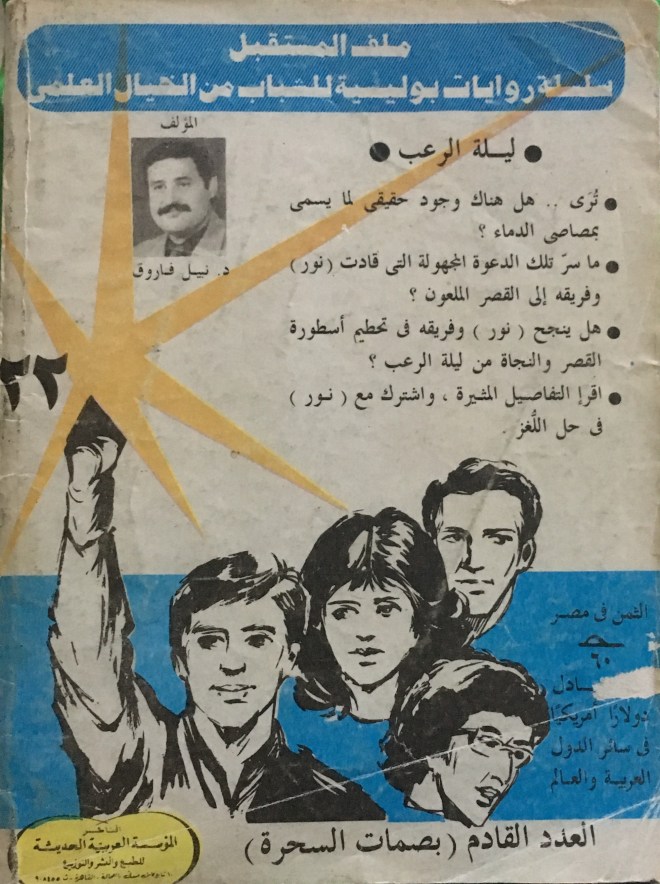عن الأفكار التي نتركها لتختمر..
عندي حكاية صغيرة مع أغنية “توأم روحي“.
كنت صبيّة لا أهتم بالأغاني كثيراً. نشأت في أسرة محافظة، لا تمانع الموسيقى، ولكن لا تجدها مهمة كفاية كي تعطيها الوقت. بنات الخالة، أكبر مني بما يقارب العشر سنوات، كنّ في أوجّ مراهقتهن، والأغاني جزء مهم من الحياة في بيتهم. الأغاني الخليجية وبعض من أغاني مصرية. بالتأكيد ليس من بينها أغاني راغب علامة. بنات خالتي قررن أن توأم روحي ” سخيفة”. وبالتالي من الطبيعي أن أقرر كذلك أن توأم روحي سخيفة.
في يوم من الأيام زارتنا، أوبالأحرى زارت بنات خالتي، قريبة أحبها من الظهران. وخرجنا لنتغدى في فدريكرز حراء (أضحك من الذكريات المفاجئة!)، ولأن السيارة كانت ممتلئة على آخرها، كنت في الدور الأعلى من الراكبات، تحتضنني القريبة الزائرة. من تجلس في المقعد الأمامي فتحت الراديو على إم بي سي إف إم- طبعاً! لم تكن هناك قناة تستحق السماع سواها على ما يبدو- وطلعت ” توأم روحي”. قالت إحدانا: ” يوووه!” لكن الزائرة قالت ” خلّوها!”، فخلّوها.
قلت لها: ما أحبها. قالت ويديها رفيقة تحتضن وسطي: ليييييش؟ سمعتيها؟ اسمعيها. ” عمل حلو”.
كنت طفلة متأملة. أرسم العلاقات بين المفاهيم والأفكار لأحاول أن أفهم العالم الصعب المعقّد الذي يبدو سهلاً للكل فيما عداي. أتذكر أنني قضيت أياماً كثيرة أتساءل عن فكرة كيف أن الناس المهمة صاحبة الآراء التي أحب وأعتنق، لا يتشاركون الرأي نفسه. وكيف أن علي أن أعطي نفسي فرصة كي أتأكد من أن ” العمل الحلو” لا يفوتني لأن البقية لم يروا جماله. يااااه، تصوّري إن في أشياء حلوة ما أعرف أنها حلوة.. ألن يكون هذا مؤسفاً.
ربما كانت المرة الأولى التي أتعامل فيها مع مفهوم الرأي المستقل كفكرة مُجرّدة.
لكني لم أكتب هذه التدوينة للحديث عن الرأي المستقل.
أكتبها لأنني قبل أسابيع استمعت بالصدفة لـ” توأم روحي” بعد سنوات وسنوات من الانقطاع. لم أفكر فيها منذ ذلك الوقت على ما يبدو، لكنني تفاجأت بأنها ” عمل حلو” فعلاً. صحيح أن لمسة صلاح الشرنوبي والضجيج الموسيقي التسعيناتي المصاحب لها موجود فعلاً، لكنه لم يعد مهماً كثيراً. ما همّني وقتها هو النسمة التي هبّت من أيام طيّبة وبريئة- لا، لم تكن سهلة- والحنين الرفيق في العبارة الموسيقية ” مش قادر أحكي لك عاللي بيجرى في بعدك”.
يبدو أن الأفكار. كل الأفكار، الممتازة والجيّدة كفاية على حدٍ سواء، تحتاج إلى الزمن لتختمر. ليس فقط كي تتكون، بل لتكون أيضاً. لتأخذ حقها في الحضور، وفي وعي المتلقّي. تصبح الأعمال التي تمثلها نافذةً مطلة على الزمن. وكأنما شاركتك رحلة من العمر، لكنها توقفت ولم تتغير، وأنت مضيت لحال سبيلك. كبرت، نضجت، أحببت، كرهت، تمتّعت، تألّمت. ثم تعود إليها فجأة، فتتفاجئ بوفائها لك. وبوقعها على روحك.
تمام. ما المستفاد من هذا الحديث عدا التأمّل في ملكوت الله اللا حسّي؟ التأمّل في حدّ ذاته يكفي، لكني الحقيقة أخذت الفكرة نفسها لآخر امتداداتها. ماذا عن الأفكار، والأعمال، التي أريد إطلاقها. ربما علي حسبان المدة الزمنية التي تحتاجها بعد تكوّنها لتكون مؤثرة في الوعي. بمعنى. هذه التدوينة مثلاً. مقالة معقولة، ستعجب البعض وتمسّ أفكاراً موجودة سلفاً لديهم، والبعض الآخر سيمرّ عليها مرور الكرام. ربما يحدثني عنها بعض الأصدقاء الأعزاء، وأربّت على كتفي بأنني قد استمررت في الكتابة يوماً آخر. ثم أعتبر أثرها قد انقضى. أخذت الفكرة الوقت اللازم للانطلاق، التأثير.. وحان وقت الأرشفة، والنظر لفكرة قادمة.
لكن ماذا لو كان لكل ذرة عمل تطلقه للعالم التأثير نفسه الذي سمح به الزمن لأن يكون ل” توأم روحي”؟ ماذا لو كان مرور الوقت، في حد ذاته، هو عامل استثماري يعتّق الفكرة ويزيد من أهمّيتها لدى المتلقّي؟
ماذا يقول دكتور مشاري النعيم في مقاله العظيم ” فأما الشهد فيذهب جفاءً“؟ ” عملت خلال حياتي على عدد من المشروعات التي أعتقد أنها مهمة، ولم يطلب أو يكلفني أحد بعملها، واشتغلت عليها بصورة موازية لعملي الرسمي الذي كانت تتنازعه الفقاعات المؤقتة، والآن بعد مرور سنوات طويلة لم يبق فعلا إلا تلك الأعمال الموازية التي لم يرها أحد في حينها وأثناء عملها”.
في وقتها؟ التفت إليها بعض البعض. مع مرور الزمن عليها، وقفت الأعمال كهامّة لم يزدها العمر إلا عُلوّاً.
هذه فكرة مهمة. لم؟ لأنها تضع أمامك، كمطوّر الفكرة، سياقاً أكثر حكمة وذكاءً لحساب تأثيرها وعائدها الاستثماري، خصوصاً ذلك السياق الذي تفرضه علينا فورية السوشيال ميديا وحسابنا لتأثير الأعمال باللايكات وعدد القراءات خلال اليوم.
إن ارتأيت مثلاً أن تنشر كتاباً اليوم، التفكير في أن الزمن سيضيف القيمة إليه، يجعلك تتغاضى وتتجاوز عن فورية الترحيب، أو اللاترحيب، الذي سيستقبله من جمهورك اليوم. خمسة فقط اشتروه؟ لم يصلك ردود عليه؟ معليش. اتركه في المكتبة، وانتظر الزمن بجهوده العملاقة- وإن كانت سلحفائية- ليقوم بدوره.
حديثي هذا لا أقصد منه الاستخفاف بجهود التسويق والتوزيع للمنتج الإبداعي. أبداً. بل أن هذه المسألة تثير ليس فقط اهتمامي، بل شهيّتي للتحليل والتخطيط (أنوي قريباً أن أتناول هذا الموضوع). ما أقصده هو أنك إن قررت أن تضع طاقتك في تسويق عملك، أو قررت ألا تفعل، الأمر سيان عندما يعود الأمر للقيمة التي يضفيها مرور الزمن على عملك. لا يمكنك تسريع العجلة، كل ما يمكنك فعله هو الإيمان بدورها، وتلقّي خيّراتها في الوقت المناسب.
أكمل دورك أنت أيضاً. أن تعاود التركيز على الأشياء القيّمة التي تستطيع إنتاجها في حياتك. عمل، وراء عمل، وراء عمل.
هذا هو الاستثمار الحقيقي.. الزبد، كما تعلم، يذهب جفاءً بالتأكيد.